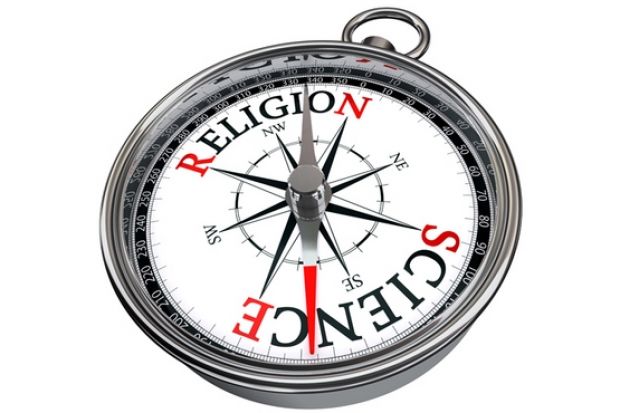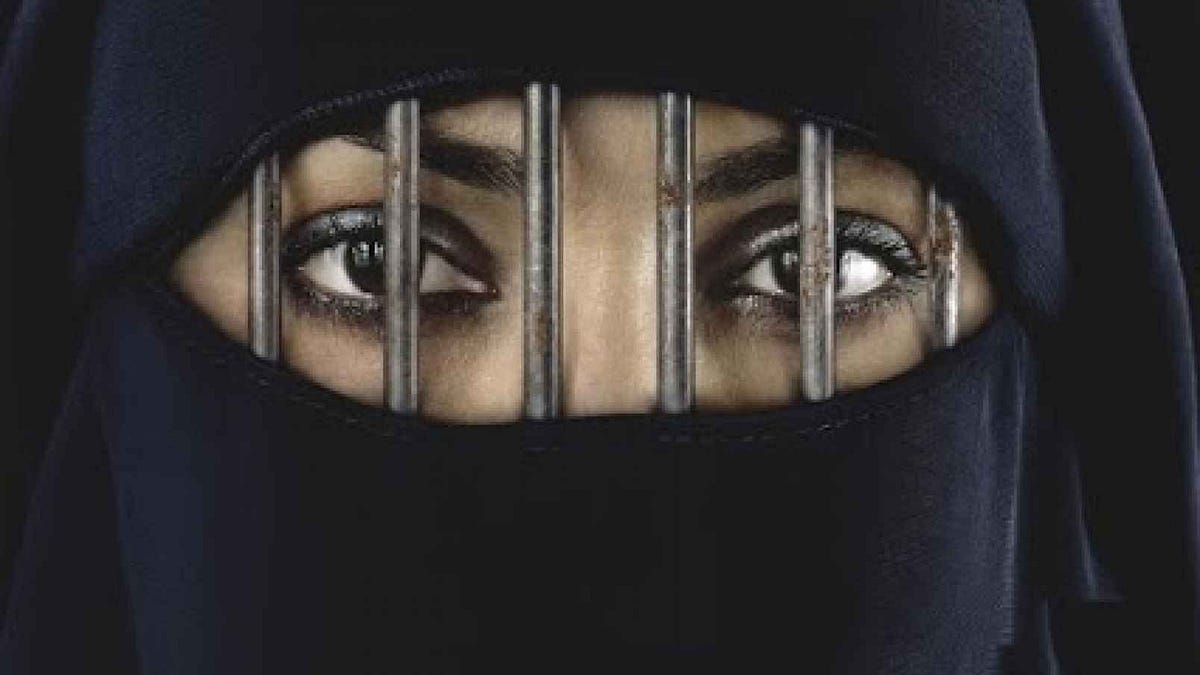1.
هل البرهنة على وجود الله قضية دينية/إيمانية، هي خارج حدود
العلم والبراهين العلمية، أمْ على العكس من ذلك، هي قضية علمية، بل وعلى العلم
التصدي لها كأية قضية أخرى تتعلق بمشكلات الوجود؟
2.
إنه سؤال طالما تم طرحه من قبل الكثير من الكتاب والعلماء،
مثلما تم التغاضي عنه من قبل الكثير من العلماء والكتاب أيضاً!ولا يختلف من حيث المبدأ أولئك الذين تغاضوا عن الإجابة
عليه عن أولئك الذين أجابوا بكون الله والدين قضية إيمانية ولا مكان فيها للعلم.
لأنَّ الأمر، في الحالتين، يتعلق بنوع من آليات التَّهَرُّب من الإجابة.
3.
ولكن إذا كان تهرب المتغاضين صامتاً، فإنَّه وعندما يكون
السائل والمجيب في الحالة الثانية عالِماً، فإنَّ الأمر يثير الشكوك بجدية منطقه
العلمي ومدى شجاعته العلمية. وهو في أحسن الأحوال التستر خلف "لا أدرية"
مشبوهة.
ربما كان ريتشارد دوكينز من أكثر العلماء المعاصرين صراحة
والتزاماً بمبادئ المنطق العلمي وبطرحه الواضح للمشكلة في "وهم الإله": إن وجود
الله لا يختلف عن أية قضية تخضع إلى منطق العلم وإن البرهنة على وجود الله أو عدمه
هي من صميم العلم.
وهذا هو عين التفكير العلمي.
4.
المشكلة لا علاقة لها بقضية الإلحاد (رغم أنَّ الملحدين
وبحكم نظرتهم إلى للعالم أكثر ميلاً لطرح هذا السؤال والبحث عن إجابات مقنعة)، بل
بضرورة الإجابة على الأسئلة المتعلقة بقضايا الوجود. إنَّ الإيمان بوجود "الله" أو
عدم الإيمان ليست قضية ثانوية لا أهمية لها، بل إنَّ الإجابة على هذا السؤال له
تبعات ثقافية وفكرية وسياسية واجتماعية تؤثر بصورة مباشرة في حياة البشر وعمليات
التطور. إنَّ الإيمان الشخصي بوجود "الله" شيء والعقيدة اللاهوتية بوجود الله شيء
آخر. ورغم التقاطعات المتعددة الخصائص والنتائج بين نوعي الإيمان، فإنَّ العقيدة
اللاهوتية تسعى (بغض النظر عن أشكال التعبير) إلى استيعاب الحياة المدنية والسلطة
السياسية على حد سواء.
ولهذا فإنَّ الإجابة على قضية وجود الله أمرٌ يعني الإجابة
على قضية شرعية/أو عدم شرعية الادعاء اللاهوتي على التدخل في السلطة المدنية
(الأرضية) وتحميل القوانين المدنية بالعقائد والأحكام الدينية. فبطلان وجود الله
بطلان هذه الشرعية.
5.
الدين والدولة:
إنَّ المطالبة الملحة للاهوت الإسلامي بأحقية الدين في نظام
الدولة لا يختلف من حيث المبدأ عن مطالب الكنيسة (بغض النظر فيما إذا كانت
كاثوليكية أو بروتستانتية أو أرثوذوكسية) إطلاقاً. غير أنه ثمة فارق جوهري وحاسم
بين نوعي المطالب: هو أن تطور المجتمعات والدول الغربية قد أدَّى بصورة حاسمة إلى
فصل الدين عن الدولة وتحوله إلى مبدأ يحظى (على الأقل من الناحية الرسمية) برضى
الكنيسة نفسها. لأنَّ التطور الثقافي والسياسي للدولة الغربية جعل تلك المطالب
خارج إطار القانون ومنطق التطور الاجتماعي. وربما تتضمن الكثير من الصحة ملاحظة
توكفيل كون انفصال الدين عن الدولة يغذي على المدى البعيد نمو تأثير الكنيسة على
الناس (أنظر: الديمقراطية في أمريكا). إلَّا أنَّ الكنيسة لم تدرك آنذاك وجهة
النظر هذه. لقد كان إصرار الدولة حاسماً وعلى الكنيسة إدراك جدية هذا الإصرار وإلَّا
فإنَّ اصطدام الكنيسة بالدولة سيكون لا محالة منه، وهو، في جميع الأحوال، لن يكون
في صالح الكنيسة!
كان للكنيسة "عقلاء" استطاعوا رؤية آفاق التطور
وضرورة التكيف مع أحكام الواقع الجديد. فهل ثمة وجود لمثل هذا النوع من
"العقلاء" في الإسلام؟
6.
للوهلة الأولى يبدو هذا السؤال "معقولاً"
و"منطقياً". غير أنه، والحقُّ يقال، سيء ما يكفي لكيلا تتم الإجابة عليه!
فتَكَيُّفُ الكنيسة، وخصوصاً المركز البابوي، لم يكن حصيلة لـ
“حكمة" عقلاء الكنيسة فقط، ولا أشكُّ بوجودهم، بل كان أمراً واقعاً مفروضاً
لا يمكن المجازفة بالتعارض معه، بغض النظر عن أشكال المعارضة المتطرفة التي حدثت
هنا وهنا (كما حصل مثلا في أسبانبا في ثلاثينيات القرن العشرين).
إنَّ إصرار وعزم
الحركة السياسية والفكرية والاجتماعية وما تحمله من ميراث عصر النهضة وعصر التنوير
والثورة الفرنسية ما يكفي من القوة والوضوح ما جعل "السلطة البابوية"
و"عقلائها" أن يستنتجوا أنَّ "غريزة البقاء" تفرض عليهم إدراك
المستجدات التاريخية والخضوع لها: إنه لم يكن اختياراً، بل أمراً لا رجعة فيه!
لقد كانت الدول الغربية تحظى بمشروعية الوجود الذي يستند
إلى القوانين والانتخابات وتطور آليات نظم الحكم الديمقراطية وإنَّ هذه المشروعية
تتعارض مع سلطة عليا، هي من خارج البنية السياسية للدولة، كسلطة البابا مثلاً. وقد
أدركت الكنيسة هذا الأمر وما كان عليها إلَّا الانسحاب.
7.
ولهذا فإنْ كان للإسلام "عقلاء" أمْ لَا فإنَّ
الإجابة لا جَدْوَى من ورائها.
فالحقيقة الصَّارخة هي أنَّ الدولة العربية (مهما
سُمِيَّتْ) لا تستند إلى أيِّة مشروعية سياسية؛ الدولة العربية هي دولة اغتصاب
واستحواذ "زُمَر" عسكرية أو مدنية أو عائلية تسير الحكم بوسائل القمع
المنظم والمخابرات، وفي بعض الأحيان عن طريق الرشوة ـ حين تتوفر
الإمكانيات الاقتصادية لذلك.
أمَّا الانتخابات التي تقيمها البعض منها فهي
"تظاهرات" مضحكة للتعبير عن قيم "ديمقراطية" لا وجود لها في
رؤوس "المنظمين" لها. بل إنَّ أعتى الحكومات العربية هي الأكثر ولعاً
بين الجميع في إقامة الانتخابات. فحقيقة كون أغلب الرؤساء العرب لا تنتهي مدة
رئاستهم إلا بالموت بسبب الشيخوخة أو الاغتيال أو عن طريق انقلاب كارثي على
البلاد، يكشف عن حقيقة "الانتخابات العربية"!
أما ما يتعلق بحالة
"لأمراء!" و"الملوك!" فالأمر لا يختلف: فآليات التصفية الجسدية والاغتيالات والإحتراب
ما بين مراكز القوى القبلية/العائلية وإبعاد بعضهم البعض عن مراكز السلطة وتولي
العرش هي حقائق يعرفها القريب والبعيد.
8.
إنَّ مصالح الحكومات العربية لم تفترق يوماً عن مصالح مراكز
السلطة الدينية الإسلامية. فأنظمة الحكم العربية ما كان لها أن تبقى بدون السلطات
الدينية وما كان للأخيرة من وجود بدون سلطات الدولة. وبالتالي فإن وجود مثل هذا
النوع من السلطات السياسية بحاجة ماسَّة إلى "ورشٍ متخلفة" لصناعة
الأوهام والخرافات تستسيغها النسبة الكبرى من السَّكان الغارقة بوَحْلِ الجهل والأميَّة.
والدين الإسلامي يوفر "بكرم" هذا النوع من "الورش"!
9.
فرضية
طاعة الإمام السلفية:
وهذا هو بالضبط ما فعله السلفيون فقهياً وعملياً (على
اختلاف انتماءاتهم المذهبية) منذ بداية ما يسمى بـ “عصر التدوين". فقد
"تفننوا" في إيراد "الأحاديث الصحيحة!" والمبادئ النبوية!"
و"الفرضيات الأصولية! في دعم الحاكم الجائر والخضوع للظالم وهو أمر
يتناقض إلى أقصى ما يكون التناقض مع أفكار "العدل"
و"المساواة" و"الحق" المعلنة من قبل جميع مدونات الإسلام التي
يتبجح بها رجال الدين المسلمين وأبواقهم من أنصاف المتعلمين والحاصلين على شهادات
الماجستير والدكتوراه بأطروحات من نوع "النجاسة في الفقه الشافعي" أو
"أصول الدين الخمسة والتكنولوجيا" وغيرها من السخافات الجامعية!
10.
فمثلما حرصت الدولة على الحضور الرسمي للدين، فإن ممثلي
السلطة الدينية وعلى مر العصور حرصوا على وضع فرضيات دينية تدعم شرعية سلطة
الخلفاء والسلاطين والحكَّام (بغض النظر عن الأسماء والاتجاهات والطوائف) وتبريرها
فقهياً وتسويغ آلِيَّات دينية كانت ولاتزال من شأنها تحسين وجه الدولة البشع ودفع
الناس إلى الطاعة وتحمل جورهم.
وقد سار الفقهاء على طرق مختلفة تبدأ بآليات التفسير
المضحكة والتأويلات "الانقلابية" وانتهاء بـ “وضع" عشرات
"الأحاديث الصحيحة" والمُخاطة على طول وعرض مصالح الحكام ومروراً بآلية
"الإفتاء" التي فتحوا لها "دوراً" و"مراكز" وكأنَّ
الناس لا همَّ لهم ولا عمل غير الاستفسار عن أحكام النجاسة والحيض!