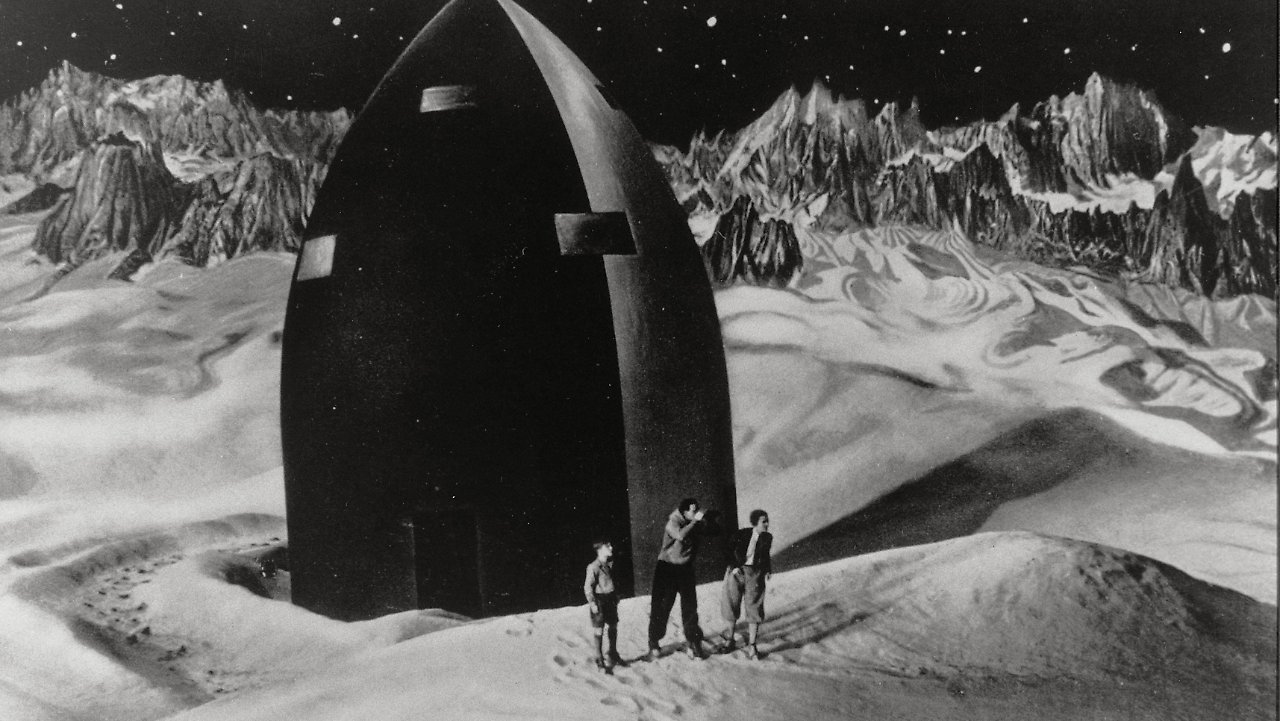1.
من مساعي مسلمي المنتديات وقنوات اليوتيوب الدعوية هو صناعة تصورات مزيفة عن الإلحاد. ومن بين أكثر هذه التصورات المزيفة انتشاراً هو أنَّ الإلحاد "عقيدة" لا تختلف عن بقية الأديان.
بل أنَّ هذا التصور المزيف يمكن العثور عليه في الكثير من المؤلفات لكتاب غربيين.
2.
فالإلحاد ما كان ولن يكون في يوم ما عقيدة دينية. وحين يتحول الإلحاد إلى "عقيدة" فإنه لم يعد إلحاداً بل كلاماً فارغاً.
لا يوجد في الإلحاد مراجع، ولا كتب مقدسة، ولا خطوط حمراء في التفكير.
الإلحاد أولاً قضية شخصية محضة. ولهذا لا يمكن أن تتحول إلى "دين".
والإلحاد ليست قضية تبشرية ثانياً. فنحن لا ندعو إلى تحول المسلمين إلى الإلحاد - كما يسعى المسلمون إلى فرض الإيمان الديني على الآخرين.
الملحدون يعبرون عن تصوراتهم المتعلقة بالحياة والكون والبشر والجنس والحب والحروب ومناهضتهم للكراهية والفاشية الدينية وقمع الحريات ومصادرات حقوق البشر والإرهاب الديني الأسود وكل ما يتعلق بحق الحياة والتفكير والرأي.
وهذا هو المنطق العلماني للمنطلقات الإلحادية:
كن ما تشاء ولكن ليكن لنفسك فقط أولاً؛ واحترام القوانين المدنية التي يتم قبولها من قبل البرلمانات من غير وصاية دينية أو تدخل لاهوتي أو ألعاب كهنوتية.
لمعلوماتك الفقيرة:
العَلمانية ليست ضد الأديان بل ضد تدخل الأديان في الحياة العامة. والملحدون الحقيقيون [وليس المزيفين] علمانيون من حيث المبدأ.
2.
فكما هو واضح أنت لا تميز ما بين التصورات الفكرية والإيمان الديني.
فخلافاً للعقيدة الدينية التي يغرق فيها المؤمن إلى أذنيه، وتجعله مستعداً لقتل الآخرين إن اختلفوا معه أو خالفوه، الإلحاد موقف رافض لوجود الطناطل والآلهة والسعالي والأنبياء والملائكة والجن وكل ما يدخل في إطار هذه الخرافات.
وموقف الرفض هذا يستند إلى التفكير النقدي والتصورات العلمية:
منذ أن ظهرت الأديان التي تسمى "إبراهيمية" إلى الآن لم يقدم مسلم أدلة تستحق الاحترام ولا تقبل الشك والجدال حول وجود خرافة "الله".
أما ما يسمى بـ"الأدلة العقلية" فهي في جوهرها "خزعبلات عقلية".
3.
إن تقديم "دليل" على وجود الطناطل والآلهة والسعالي والأنبياء والملائكة والجن قضية تسمى oxymoron - أي تناقض لا يمكن تذليله.
فالدين إيمان ولا علاقة ما بين الإيمان والموقف العقلاني النقدي الذي يستند إليه منطق الدليل.
4.
الإيمان: هو القبول التسليمي والخضوع الساذج للخرافات والأساطير.
أما الإلحاد فهو موقف نقدي عقلاني يستند إلى منطق العلم لرفض الخرافات والأساطير لكي تتحول إلى عقيدة دينية فاشية مضادة للحريات الشخصية.
وهذا هو الدليل:
مهما كذَّب المسلم ودلس وزيف وخلط الأوراق فإنه لا يمكن للملحد أن يعبر بصورة واضحة جلية مكشوفة لا لبس فيها عن مواقفه الرافضة للدين في منتدى إسلامي.
أما المسلم فإنه يستطيع التعبير عن عقيدته الدينية بصورة واضحة جلية مكشوفة لا لبس فيها في منتدى للملحدين ولكن من غير شتائم وسباب وتجريح وتهجم على طريقة الجوامع والقنوات الإسلامية المبتذلة!
الخلاصة البسيطة:
الملحد لا يؤمن بـ"اللاشيء". فهذه أمنية كهنوتية وحلم إسلامي لا مكان لهما على أرض الواقع مطلقاً.
فلتحلمْ كما تشاء. فأحلام النوم واليقظة ليست ممنوعة في منتدى الملحدين - كما يحدث عادة في مملكة الإسلام المظلمة!